لماذا دوستويفسكي؟
قراءة نقدية في أدب فيودور دوستويفسكي وفكره
مقالات في النقد
عمر الشيخ
3/9/2018

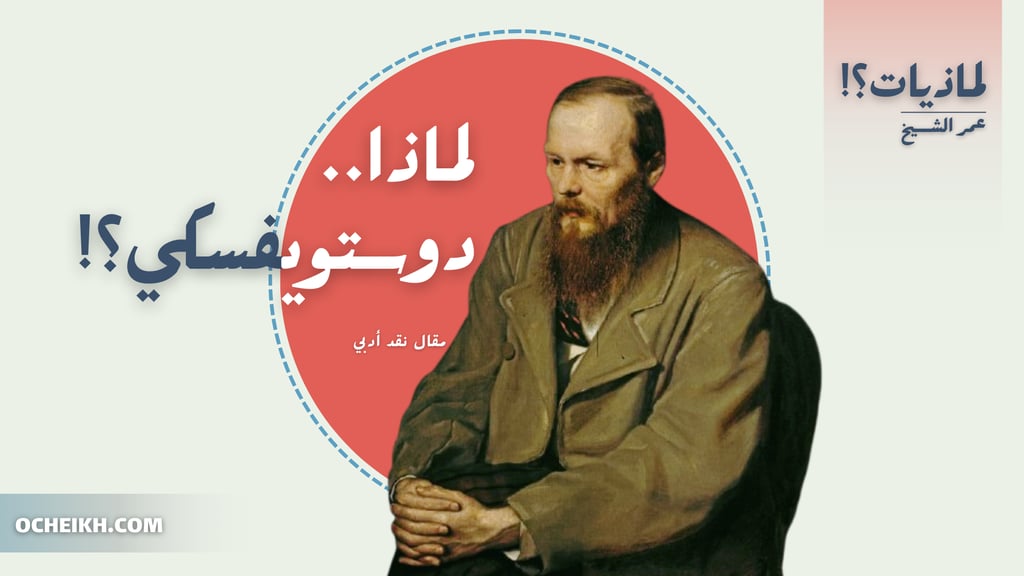
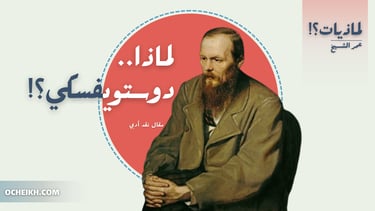
لماذا دوستويفسكي؟
قراءة نقدية في أدب دوستويفسكي وفكره
يستحيل الحديث عن الأدب العالمي دون التوقف أمام اسم فيودور دوستويفسكي (1821–1881)، فهو الأديب الذي استطاع، عبر شخوصه وأحداثه وروحانيته العميقة، أن يعيد تشكيل نظرتنا للنفس البشرية. وما تزال أعماله تحظى باهتمامٍ واسع بين الأوساط الأدبية والفكرية حتى اليوم. بيد أن لحظةً مفصلية واحدة -في رأيي- أسهمت في تشكيل رؤيته الوجودية بوضوح: لحظة الحكم عليه بالإعدام.
ففي إحدى أكثر المحطات دراميةً في حياته، عاش دوستويفسكي تجربة انتظار تنفيذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص قبل أن يُعفى عنه في الدقائق الأخيرة. تلك الواقعة تركت أثرًا لا يُنسى في وعيه، وأعادت صياغة علاقته بالزمن والموت والحياة والحرية والذنْب والخلاص. وانطلاقًا من هذه اللحظة الحاسمة، يمكن فهم كثيرٍ من المسارات الفكرية والشعورية التي أثّثت فضاءات رواياته التالية، التي بدورها تدفع القراء والدارسين على حدٍّ سواء للتساؤل: “لماذا دوستويفسكي؟”
إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال تقتضي منا الوقوف عند خصوصية مشروعه السردي، وعمق بصمته الفكرية، إضافةً إلى تفحص الأبعاد الفلسفية التي رسّخت مكانته الفريدة ضمن سياق الأدب العالمي.
لحظة الإعدام المؤجلة وأثرها في تشكيل الرؤية
في عام 1849، قُبض على دوستويفسكي مع مجموعةٍ من المفكّرين المنخرطين في نشاطٍ سياسي يُعدّ معارضًا للسلطة. وبعد أشهر من التحقيق، صدر الحكم بإعدامه رميًا بالرصاص. ووفقًا لما رواه هو نفسه لاحقًا في رسائله ومذكراته، فقد سيق مع زملائه إلى ساحة الإعدام، ورُبطوا على أعمدة في انتظار تنفيذ الحكم فيهم. وفي اللحظات الأخيرة، صدرت الأوامر بوقف التنفيذ، ليُستبدل العقاب بالنفي إلى سيبيريا والأشغال الشاقة. تلك الدقائق التي اعتقد فيها أنّ شعلة حياته أوشكت على الانطفاء شكلت منعطفًا جذريًا في وعيه: إذ اختبر من خلالها الارتعاد أمام شبح الموت، وشعر بحبٍّ مفاجئ للحياة وتشبثٍ بالوجود رغم قسوته.
في إحدى رسائله، كتب دوستويفسكي لاحقًا مستذكرًا: “إذا قُدِّر لي أن أعود إلى الحياة، فسأتحسس كل دقيقة كما لو كانت حياةً كاملة.” وما ستؤول إليه رواياته اللاحقة يمكن ننظر إليه بوصفه سعيًا لتجسيد هذا الشعور المستفيض بقيمة الحياة ووطأة الذنب وفكرة الخلاص من براثن الخطأ.
الخصوصية السردية وصراع الخير والشر
انعكست تجربة انتظار الموت على المنحى الدرامي لأعمال دوستويفسكي، إذ صارت ثيمة الصراع الوجودي بين الخير والشر، والتوق الدائم للخلاص، من أبرز موضوعات رواياته. ففي رواية "الجريمة والعقاب" المنشورة (1866)، نتابع بطل القصة راسكولنيكوف الذي يرتكب جريمة قتل بدافعٍ من نزعةٍ فرديةٍ استثنائية، ثم يعاني عذاب الضمير حتى يجد بابًا للغفران في الاعتراف والتوبة. هنا يتجسد الإحساس بالحياة مرادفًا للحرية التي كاد دوستويفسكي أن يفقدها إلى الأبد. وتستكشف الرواية مفهوم الخير والشر، التوبة، والعدالة الإلهية، مسلطة الضوء على تأثير الفقر والعزلة على الإنسان. تعكس الأحداث والحوارات الداخلية للقصة رحلة البطل من التبرير الأخلاقي للجريمة إلى الشعور بالذنب والسعي للتكفير، مما يجعلها تأملًا عميقًا في النفس البشرية ومعاني العدالة والعقاب.
أما في الأخوة كارامازوف المنشورة (1880)، فنجد شخوصًا تتصادم فيما بينها فكريًا وروحيًا، وكأنّ كلًّا منها ينطق بإحدى طبائع النفس الإنسانية: الإيمان، الشك، الشهوة، محاكمة الخالق، أو التسليم لإرادته. وقد استطاع أن يصنع منها تحفة أدبية تتناول قضايا فلسفية ودينية وأخلاقية عميقة من خلال قصة صراع بين ثلاثة أشقاء مختلفي الطباع، تجمعهم علاقة مضطربة مع والدهم المستبد فيودور كارامازوف. وتعكس أحداثها وحواراتها المطولة الصراعات والتساؤلات الداخلية للشخصيات حول الإيمان، الإلحاد، الحرية، والمسؤولية الأخلاقية، في سياق تحقيق حول جريمة قتل والدهم التي تتشابك فيها دوافع الشك والجشع والغيرة.
وفي أحد أببرز حواراتها، يقول إيفان لأخيه أليوشا ما معناه: “إن كنتُ أرفض عالمًا يقف على جثّة طفلٍ واحدٍ بريء، فأين مكان الله من هذه المأساة؟” هنا يلخّص دوستويفسكي عبر صوت إيفان جوهر التساؤل الإنساني عن الشر والمعاناة، وهي الأسئلة التي ما انفك الأديب الروسي يُعمّقها متأثرًا بإحساسه المُلحّ بقيمة كلّ لحظةٍ من لحظات الحياة.
البعد النفسي وتعدد الأصوات
تميّزت نصوص دوستويفسكي بتقنيةٍ سرديةٍ استثنائية تتسم بتعدد الأصوات وتلاقحها. ففي رواية الشياطين المنشورة (1872) مثلًا، يُفسح المجال لتلاقي شخصيات ذات توجّهاتٍ ثوريةٍ متضاربة، تكشف عن مكنونات بشريةٍ تعجّ بالفوضى والاضطراب، وكأن كل شخصية تنطق برؤية منفصلة للعالم- فهي تارةً تحمل الحماسة الثورية، وتارةً أخرى تُفصح عن مكامن اللاجدوى. إنّ الإنسان هنا يظهر هشًّا وعرضةً للسقوط في أفخاخ الأيديولوجيات المغلقة.
لطالما ربط الدارسون هذا التعدد في الأصوات في سرده بمدى تعقّد الوعي لدى دوستويفسكي نفسه، وخاصةً عقب لحظة الإعدام المؤجلة التي جعلته يرى الحياة بوصفها حقلًا شاسعًا من التضادّات والتناقضات. فهو يمنح لشخوصه حرية التعبير عن قلقها وتوقها، فلا يعود هناك بطلٌ مطلق الخير أو مطلق الشر، بل شبكةٌ من المصائر والأفكار التي تتساوى في إمكانية الصواب والخطأ.
رصيد المعاناة الشخصية بوصفه أداةً للخلق الفني
لا ينبغي أن نغفل أنّ دوستويفسكي عاش على نحوٍ متواصلٍ ضربًا من المعاناة المادية والصحية، ما عمّق تماهيه مع فئات المهمّشين والأكثر فقرًا في المجتمع الروسي. ففي سجنه في سيبيريا، احتكّ بشتى أطياف المجرمين والمتهمين والمنفيين، فرأى فيهم نماذج حية تعيد على مسامعه حكاياتٍ عن عذابات الروح البشرية والقدرة على البحث عن التوبة ونوافذ الرجاء.
ويمكن أن نتلمس في رسائله إشاراتٍ عن إدراكه مدى بساطة الخطوة التي تفصل المرء بين الخطيئة والفضيلة، والرضا والندم، بل إنه يقول في موضعٍ ما: “رأيتُ في العتمة أقصى درجات النور”.
ولعل هذا التناقض يحيلنا إلى شخصياتٍ مثل سونيا في "الجريمة والعقاب"، الفتاة التي تعيش في أحلك ظروفٍ اجتماعيةٍ ممكنة، لكنها تحمل قلبًا مؤمنًا قادرًا على استيعاب خطيئة راسكولنيكوف وفتح طريق الخلاص أمامه. إنّ دوستويفسكي يستلهم هذه الشخصيات من روح تجاربه الشخصية، وكأنه يدوّن شهادته الحية على امتزاج القبح بالجمال، والظلمة بالنور، وعبث الوجود بمعناه الأخلاقي العميق.
التأثيرات الفلسفية والدينية في أعماله
على الرغم من أنّ دوستويفسكي سبق رسميًّا المدارس الوجودية، فإن كثيرًا من أعلام الفلسفة الوجودية والفلسفة العبثية - أمثال جان بول سارتر وألبير كامو- استلهموا منه مفهوم الحرية الإنسانية والتمرّد الفردي في وجه الأقدار الاجتماعية والدينية.
لقد كانت ثيمات كالذنْب الأخلاقي، والتوق إلى الخلاص، والمساءلة الدائمة للخالق عن الشر، أرضيةً خصبةً وجد فيها الوجوديون والعقلانيون جذورًا لجدالاتهم الفكرية. وفي الوقت عينه، يعكس انتماؤه إلى التراث الأرثوذكسي الروسي نبرةً روحانيةً ترى في المسيح المثال الأعلى للحب والتضحية. يتجلّى ذلك في رواية "الأخوة كارامازوف" من خلال حكاية “المفتش الأعظم” التي يسىدها داخل الرواية على لسان إيفان كارامازوف، حيث نرى المسيح يعود إلى الأرض فيتعرض للاعتقال والمساءلة من قبل رجل الدين المهيمن. هنا تتفجّر مفارقات الوجود والحرية، ويختلط المقدّس بالزمني، ما ينتج نقاشًا عن جدوى الإيمان والقسر الديني، وينبثق تساؤلات فلسفية عميقة حول طبيعة الحرية، والسلطة، ومسؤولية الإنسان الأخلاقية.
أعماق النفس البشرية والتقنية الحوارية
رسم دوستويفسكي شخصياته بحيث تكون مرآةً للعالم النفسي بأسره؛ إذ حملت كل شخصية صراعًا داخليًا متشظيًا بين إغراء الرذيلة والإيمان بالفضيلة، بين الخضوع للشهوات والالتزام بالواجب، بين العصيان والخضوع. وفي مواضع كثيرة من رواياته، نجد حواراتٍ مطوّلة تتخذ طابع “المناظرة الفلسفية”؛ فالشخصيات تحاجج وتمارس اعترافًا متبادلًا، وفي الوقت نفسه تغوص في إدراك الدوافع العميقة لكل طرف.
وفي إحدى الحوارات الشهيرة في الأخوة كارامازوف، يطرح إيفان على أليوشا مشكلة “الشر اللّا محدود”، ويتساءل: ما قيمة النظام الكوني إذا كان ضحيته طفلٌ بريء يصرخ من الألم؟ هنا نرى كيف يرسم الكاتب مشهدًا حواريًا يختصر أزمة الإنسان مع الشر والخير، ويردّ أليوشا بحجةٍ إيمانيةٍ بسيطة: المحبة هي التي تتغلب على الكراهية، وتمنح الحياة طاقتها الأسمى.
وصف عالم النفس الشهير سيغموند فرويد دوستويفسكي بأنه "أعظم عالم نفسي في الأدب". حيث رأى في أعماله تحليلات عميقة للأمراض النفسية، مثل عقدة الشعور بالذنب، والرغبة في التدمير، وصراعات الهوية. تأثر فرويد خصوصًا بشخصية إيفان كارامازوف وصراعه مع فكرة الإله، معتبرًا أنها تمثل شكلاً مبكرًا من التحليل النفسي الذي سبق زمنه.
أثر دوستويفسكي في الفلسفة والأدب الحديث بطرحه الأسئلة الكبرى حول الإنسان والوجود. ألهم أعمال نيتشه وكافكا وكامو، حيث اعتُبرت رواياته استكشافًا لما سماه ألبر كامو "المتاهة الأخلاقية للإنسان". إبداعه يكمن في جعله القارئ شريكًا في معاناة شخصياته، حيث يُظهر كيف يمكن لأبسط الأحداث أن تُحدث عواصف داخلية، وهو ما يجعل أدبه خالدًا وذا تأثير عميق على الفكر الإنساني.
دوستويفسكي لم يكن مجرد روائي، بل كان طبيبًا للنفس البشرية، يكشف جراحها ويضع القارئ أمام مرآة ذاته، ليختبر معاني الصراع والتوبة والحرية في عالم مليء بالتناقضات.
وشخصيًا، أرى أن دوستويفسكي أحد أعظم الأدباء الذين أبدعوا في استكشاف أعماق النفس البشرية؛ فرواياته تكشف عن التناقضات الداخلية في الروح الإنسانية والصراعات العميقة التي يعيشها الإنسان بين الإيمان والشك، الحرية والخضوع، الخير والشر. ويظهر هذا التوتر النفسي من خلال تقنية تعدد الأصوات (Polyphony)، حيث لا تُمثل الشخصيات مجرد أدوات لخدمة الحبكة، بل كائنات مستقلة تعبر عن أفكار ورؤى متباينة، مما يجعل القارئ أمام مناظرات فلسفية وأخلاقية تسبر أغوار العقل والروح.
إذن، لماذا دوستويفسكي؟
إنّ اللحظات التي عاشها دوستويفسكي في ساحة الإعدام ينتظر فيها انظفاء شعلة حياته على يد سجانه قبل أن يُعفى عنه، لم تكن سوى واقعة حية أججت في روحه نارًا لا تنظفئ من الإبداع، وستظل حاضرةً في عمق مشروعه الأدبي والفكري. فذلك الحدث -من وجهة نظري- أجّج في نفسه توقيرًا للحياة وقناعةً هشّةً بأن كل لحظة يمكن أن تكون الأخيرة، ومن ثمّ بات ينظر إلى الناس كمخلوقاتٍ تتخبط بين الطموح والسقوط، بين نور الإيمان وظلمة الخطيئة. ولمّا كان صخب العصر ووحشة الفقر يحيطان به، صارت رواياته بمثابة مناجاةٍ تمتد بين الأرض والسماء، يُلمِح فيها إلى أنّ النجاة ليست مجرد خلاصٍ دنيوي، بل أيضًا امتحانٌ روحي يستدعي استنطاق الحرية والضمير.
هكذا تلتئم في أدبه جدلية الوجود البشري التي طالما أرهقت الفلاسفة والمتصوفة على حدٍّ سواء، ما يجعلنا نقول إن سؤال “لماذا دوستويفسكي؟” يجد جوابه في عمق هذه الرحلة الشاهقة التي تمزج المصير الأرضي بالحاجة إلى المطلق، وتستشف في الخطيئة بذرة التوبة، وفي اليأس فكرة الرجاء. إنه صاحب التجربة الأقوى في الذهاب إلى تخوم الذنب والحد الأقصى للخوف، ثم العودة بأملٍ إنسانيٍّ لا يُكسر، أو القفز في ظلام المجهول بلا رجعة.
