لماذا المعري؟
قراءة نقدية في أدب وفلسفة أبو العلاء المعري من سلسلة لماذيات
مقالات في النقد
عمر الشيخ
2/5/2018

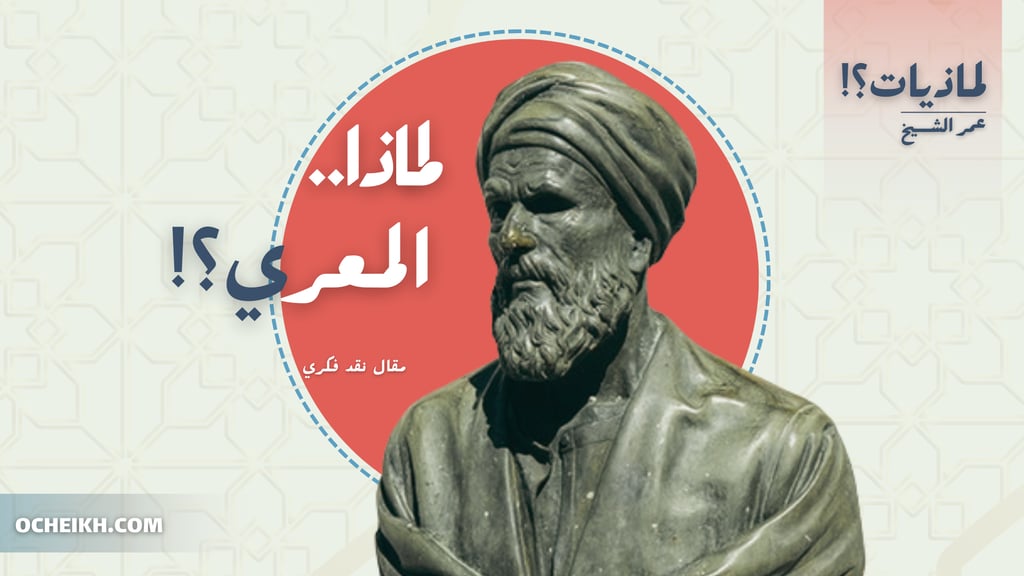
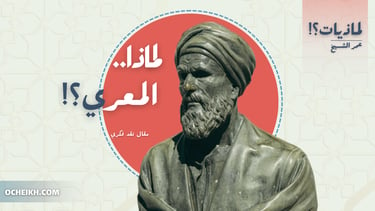
لماذا المعري؟
قراءة نقدية في أدب وفلسفة المعري
حين نعود بالزمن إلى أبي العلاء المعري (363–449هـ/973–1057م)، فإننا نجد أنفسنا في حضرة شاعرٍ فريد ومفكّرٍ نادرِ النظير في الثقافة العربية، امتاز بجرأته وحِدة طرقه وبتجريده الفكري ونقده المباشر لكثيرٍ من المسلّمات سواء الاجتماعية أو الثقافية أو حتى الدينية.
وقد وصفه الأولون بـ"رهين المحبسين": محبسه في بيته بعد أن اعتزل الناس، ومحبسه في العمى الذي رافقه منذ صغره. إلا أنّ قراءته تكشف عن عقلٍ متوقدٍ استطاع تجاوز حدود النظم الشعري إلى آفاقٍ تأملية جعلت أدبه مادةً عميقةً للدرس الفلسفي، ليس في الثقافة العربية وحدها بل لدى باحثين من آدابٍ أخرى أيضًا.
إنّ طبيعة أبو العلاء المتأمّلة تتجلّى في نزوعه التشكيكي، وفي لغته الشعرية التي تبدو للوهلة الأولى ممعنةً في الغرابة والتكلف والتقعير، لكنّها تفيض بدلالاتٍ أخلاقيةٍ وإنسانية عبقرية. من يقرأ دواوينه -كـ"سقط الزند" و "اللزوميات"- سيدرك أنّ المعري لم يكن شاعرًا غارقًا في الترف اللفظي فقط، بل كان أيضًا صاحب رؤيةٍ فلسفيةٍ تحاول أن تتلمس أصل الوجود ووظيفة الإنسان في الكون.
لكنه لم يكن مثاليًا في طرحه الفلسفي على غرار معاصريه، بل على النقيض، كان موغلًا في الواقعية الصِرفة، بل في السوداوية والتشاؤم. ولا يؤخذ ذلك على مثله.
يقول في أحد أبياته الشهيرة:
غيرُ مجدٍ في ملّتي واعتقادي
نوحُ باكٍ ولا ترنُّمُ شادي
في هذا البيت المكثف، تتضح لنا عدة طبقات: الأولى تشف عن نقد مباشر لبعض المظاهر التعبيرية المتناقضة الدالة إما على الحزن أو الفرح (كالنوح والترنّم) فكلاهاما تعابير عن مشاعر إنسانية لا قيمة لها في ميزان الحياة الفانية في فلسفة المعري الواقعية. وفي طبقة أخرى يتضح لنا أن المعري أراد أيضا انتقاد المظاهر الشعائرية المتمثلة في بعض الطقوس كالنوح واللطم في المآتم والغناء والترنم وإظهار البهجة في الأفراح. فهو يرى أن هذه المشاعر ليست إلا تهويمات اجتماعية توارثتها البشرية أجيالًا بعد أجيال، ولم تكن لتغير واقع هذه الدنيا الفانية. بل يرى إن الأجدر بالإنسان أن يتخفف من تمظهرات مشاعره، سلبية كانت أم إيجابية، فهي لا تنفع ولا تمنع، وإن كانت كذلك لنفعت الموتى أو لمنعت الضر والفناء عن الأولين الذين امتلأت بهم بواطن الأرض وفنوا هم ومشاعرهم وأفراحهم وأتراحهم.
ويقول:
خفِّفِ الوطءَ ما أظنُّ أديمَ .. الأرضِ إلا من هذه الأجسادِ
وقبيحٌ بنا وإن قدُم العهدُ .. هوانُ الآباءِ والأجدادِ
إنّه لا يقف موقف الرافض المطلق للفن أو التعبير، بل يلمّح إلى وجود مسافةٍ بين جوهر العقيدة - كما يؤمن هو به - وبين الطقوس والمُسايَرات الاجتماعية التي قد لا تحمل قيمةً حقيقية في نظره.
ولعل هذا البُعد النقدي في موقفه يعود إلى حساسيته الشديدة تجاه "الافتعال الإنساني"، أكان في الدين أو اللغة أو التقاليد.
وليست نظرته إلى الوجود بمعزلٍ عن الموت والمصير الأخرويّ؛ فهو كثيرًا ما يتطرّق للمآل الأخير للإنسان لكن بمنطق العقل لا الإيمان التقليدي. فهو لا يرى في الحياة من نفع ولا يرى في الفناء ضرر..
فتجده يقول:
تعبٌ كلها الحياة فما أعجبُ.. إلا من راغب في ازديادِ !
بل تعلو نبرة الشك عنده إلى حد بعيد، فيقول:
أفي الحق أن يقضي على الخلق كلهم .. بموتٍ وأن تبقى الحياة لواحد؟
ولا يخفى على مبصرٍ تشاؤم أبي العلاء "شيخ المعرة". لكن هذا التشاؤم بني على أساسين أحدهما التجربة الشخصية والآخر أساس فلسفي.
يقول:
هذا ما جناه عليَّ أبي
وما جنيتُ على أحد
وهو بيتٌ يأخذ منحًى فلسفيًّا لافتًا؛ إذ يعيد فيه صياغة مسألة "الخلق" و"الوجود" و"الإرادة" وعلاقة الأبناء بالآباء: هنا يصبح إرثُ الحياة نفسها "جنايةً" غير إرادية، ومن ثم لا يرى المعري نفسه مسؤولًا عما تفرضه عليه الطبيعة من تكوينٍ وجودي.
في هذا الطرح يتبدى جانب المعري الوجودي، الرافض لتعليلٍ بسيطٍ لقضايا المصير والإرادة الإنسانية، فانشغاله بتعقيدات الحياة ومعاناة الإنسان يجعله يصوغ كثيرًا من أبياته على نحوٍ يطرح أسئلةً أكثر مما يقدّم أجوبةً.
ولم تقتصر جرأته على نقد الواقع الاجتماعيّ والوجودي من خلف ستار اللغة الرمزية، بل تجاوزتها إلى تناول الشأن الدينيّ والتأمل في اختلافات الشرائع "وما تخلقه من انقساماتٍ بين البشر" بشكل فج ومباشر. فقد نسب إليه في اللزوميات قوله:
إنَّ الشرائعَ ألقتْ بيننا إحَنًا
وأودَعَتنا أفاكًا وكذابا
إنه تصريحٌ واضحٌ بأنّ الأديان، في نظره، قد تحمل في بعض تجلياتها بذور الاختلاف والعداء بين البشر، فينتقد استغلالها لإثارة الفتن أو لتبرير النزاعات. هذا الموقف الشكّي المناهض للاعتقاد الديني كان صادمًا لبيئته في العصر العباسي، خصوصًا وأنّ النقد الديني العلني نادرًا ما كان يعالج بهذا الانفتاح.
لزوم ما لا يلزم في اللغة والفكر
أما على صعيدٍ فنيّ، فإنّ شعر المعري يدور بين محورين أساسيين: الأول هو الإبهار اللغوي والتفنّن في المحسّنات البديعية والصيغ النادرة، والثاني هو العمق الفكري والفلسفي الذي يغذي تلك الصياغات. لذا تحضر كثيرًا من الصور الذهنية المكثّفة التي قد تبدو متعسّرةً للوهلة الأولى، لكنها تفصح عن منطقٍ باطنيٍّ صارمٍ عند التأمل فيها. يُضاف إلى ذلك نهجه في "اللزوميات" الذي التزم فيه ما يفوق القافية الروتينية، إذ أخذ على عاتقه "لزوم ما لا يلزم" من الحروف، فدفع ذلك شعره إلى آفاقٍ تجريبيةٍ زادت من فرادة أسلوبه.
لكنّ المعري لم يكتف بالشعر. ففي نثره نجد كتبًا ذات أثرـ أغلبها وُضع في سياقٍ يجمع بين السخرية والتفلسف، وأهمها "رسالة الغفران". وهو كتاب يصوّر فيه تخيُّلًا للآخرة حيث يتنقل عبر مناطق في الجنة وأخرى في الجحيم، مستعرضًا وضع الشعراء واللغويين والفلاسفة بين النعيم والعذاب، ومستخدِمًا روحًا ساخرةً وإسقاطات فلسفية تتأمل العدالة الإلهية والعلاقة بين الإبداع والخطيئة.
إنّ هذا العمل بعينه يُرجّح بعض الباحثين أنه أثّر على أدباءٍ غربيين كُثُر، لاسيما في رسم المشاهد (الكوميتاجيدية) التي انعكست على أعمال أدبية فنية ومسرحية لاحقا. بل إن باب كبيرًا من المقارنة فتح بينه وبين "الكوميديا الإلهية" لدانتي أليغييري.
إذ إنّ دانتي، وإن كانت معلوماته المباشرة عن الثقافة العربية موضع جدلٍ تاريخيٍّ وأدبيٍّ، فإنّ بعض المستشرقين لفتوا النظر إلى أوجه تشابهٍ بين البناء العام لرحلة دانتي في الجحيم والعالم الآخر وبين ما ابتكره المعري في "رسالة الغفران".
قد لا يكون الأمر نقلًا حرفيًا، لكن التشابهات في السرد الأخروي والتصنيف الطبقيّ لأهل الجنة والنار تثير التساؤل حول ما إذا كان دانتي قد اغترف من بحر أبي العلاء ما تيسر في هذا اللون من الكتابة الخيالية الفلسفية.
الأثر البائن والإرث الباقي
على امتداد القرون، ظلت أعمال المعري مصدرًا للإلهام أو الجدل في آن؛ فالكثير من الشعراء والمفكرين اللاحقين تعاملوا مع فلسفته بحذرٍ أو تقديرٍ، فمثلًا نجد ابن الوردي والشاعر أبو العتاهية وغيرهما يقتبسون أحيانًا من أساليبه التأملية أو يشيرون إلى جرأته الفكرية.
أما على الصعيد العالمي، فقد حفّزت أفكاره المستشرقين والباحثين على إعادة النظر في الصورة النمطية عن الأدب والفكر العربي في العصور الوسطى، إذ اكتشفوا في "شيخ المعرة" صوتًا حُرّ الفكر لم يخضع للسائد في عصره، بل اجترأ على طرح أسئلةٍ شائكةٍ حول قدر الإنسان وحقيقة وجوده. وهو أيضا ما دفع بعض المستشرقين لدراسة ذلك العصر من زاوية الانفتاح على الأفكار المخالفة عكس التصور النمطي.
إنّ فلسفة المعري قد تتلخّص في كلماتٍ قليلة، لكنها شاسعة الدلالة: وإن كان الشكُّ المنهجيّ، ونقد المسلمات، والإعلاء من مكانة العقل هي السمة العامة في طرحه. أقول (كلمات قليلة) ولا أعني بها التقليل من أعماله وفكره، لكنني أشير إلى وحدة موضوعاتها وبساطتها. فهو لم يخرج عن ثنائية الشك والمساءلة في شعره ونثره. وهذا لا يعيبه، لكنه تبيين عادل تقتضيه الأمانة ويقتضيه موقفنا النقدي من أدب الرجل وفكره. ولسنا في صدد تقييمه أو محاكمته.
إن في أدب المعري وشعره، رصدٌ عميق لمعاناة البشر التي اختزلها في سطوة أمرين اثنين ليس لهم من سلطان عليهما، وهما القدَر والمجتمع.
لكنه مع ذلك سعى إلى صياغة رؤيةٍ أخلاقية تجعل الإنسان مسؤولًا عن تجاوز الظلم أو الخرافة. ولعلّه يبدو لدى البعض تشاؤميًّا أو رافضًا للّهْو ومباهج الحياة من جهة، والدين والتسليم من جهة أخرى، (وهو بالفعل كذلك)، إلا أنه في العمق ينافح عن إنسانيةٍ حرّةٍ لا تقبل الإذعان الأعمى لأيّ سلطة، سواءٌ كانت سياسيةً أم دينيةً أم اجتماعيةً.
وإلى جانب ذلك، لا يلقي بسهمه من جاه الدنيا دون صيد، فهو معتد بنفسه أيما اعتداد، مدرك لما لعقله من ألمعية وما لأدبه من عبقرية وما لقوله من أثر ونفوذ:
وإني وإن كنتُ الأخيرَ زمانَه
لآتٍ بما لم تستطِعهُ الأوائل
هنا يعلن تمرده الأدبيّ والفكري، مُفتخرا أنّه يطرق أبوابًا لم تطرق من قبله، ويسلك دروبًا لم يسبقه لها أحد، متحدّثًا عن استشرافه الجديد في اللغة والفكر.
إنّه يقيم تحديًا مع الموروث ومع كبار الشعراء والمفكرين الذين سبقوه، ليقول إنّ زمنه الأخير لا يعني بالضرورة أنه ناقلٌ لعلوم من سبقوه مجتر لأفكارهم، بل إنه سلك من الطرق أوعرها واختار من الأشجار أطولها وأورفها وانتقى من الثمار أنضجها وأينعها في واحة المعرفة وبحبوحة الفكر.
تنعكس آثار رؤية المعري في أعمال كتابٍ عالميين كما أشرنا، ليس بالضرورة عبر الاقتباس المباشر، بل من خلال التقارب في صياغة الأسئلة الوجودية الكبرى. إن "رسالة الغفران" تمثّل ذروة المزج بين الفلسفيّ والأدبيّ في التراث العربي، وهي الجزء الأوضح الذي يقرّبنا من عالم دانتي في "الملهاة الإلهية" (أو "الكوميديا الإلهية"). فهناك مشهدٌ شبيهٌ هو نزول الراوي إلى الجحيم أو الجنة، ورؤية أهل الأدب والفلسفة كلٌّ في موقعه، مما يُضفي على الحوار بين النصين تقاطعًا واضحًا وبعدًا كونيًا مشتركًا يطرح تساؤلات حول العقاب والثواب ومصائر المبدعين، وموقف الدين من الفكر النقديّ والإبداعيّ.
إذن، لماذا المعري؟
لا يمكننا فهم المعري بوصفه مجرد شاعرٍ متلكف أو مفكر شكاك أو ملحد مجدِّف كما يصنفه البعض. بل الحري بنا أن نحاول فهمه من خلال قراءته كعقل تواق مبدع وجد نفسه حبيس جسد عليل مظلم، فأراد التحرر منه ومن كل قيد سواه، فاتخذ التمرد وسيلة للبقاء، والشك وسيلة للمعرفة، والأدب أجنحة تسمو به فوق عجزه.
إنّه عقلٌ فريدٌ اتخذ من التفلسف ترياقًا لمعالجة معضلات الوجود، ومن الشعر والنثر حقلًا للتجريب اللغوي والفكري. بعد هذا كلّه، تبدو دراسة أبي العلاء كمحطة مهمة من محطات الأدب والفكر العربي، أمرًا ملحًا. فهو يمثل صورة مبكّرة للناقد العقلاني ونواة للفلسفة التشاؤمية في التراث العربي.
ولعلّ سؤال "لماذا المعري؟" يجد الإجابة على جسر ممتد بين جدلية الألم الإنساني والرغبة المعرفية. فقد كان "شيخ المعرة" -وإن خالفناه كثيرًا- علما من أعلام الأدب العربي والإنساني، وجسر لقاءٍ بين ثقافاتٍ تمتد من حلب إلى فلورنسا، ومن فكر العصور الوسطى إلى تساؤلات الحداثة بلا انقطاع.
